ذاتَ ليلة - أو كلَّ ليلة؛ كما عهدتُ خلاياي العصبية - أتوه في شتاتِ أفكاري.
ولكن تلك الليلة كانت فاصلة.
فإما أن تقودني أفكاري لمخرج المتاهة، أو أهوِي في التِّيه.
تُرى لِمَ يخلقُ الله كلَّ تلك الحياوات، ويبُثُّها في روحي أنا لتكون حياتِي؟
حياة خلايا...
لطالما تخيَّلت الخلايا أُناسًا كلٌّ يعملُ على شاكلته.
ليُكَوِّنوا جهازًا يتشارك مهمة من مهماتٍ عِدَّة.
وتتجمع كلُّ الأجهزة في أنا، وفيَّ يَنطوي عالَم.
ثم يكون عالَم من حولك.
حياة طيور ونباتات، وجبال وأرض وسماء.
كلُّ ذلك مسخَّرٌ لأحيا أنا.
ثم توقفت!
فكيف لكل مخلوقٍ مهمةٌ مسخَّرة للإنسان، ولا يكون للإنسان مهمة؟!
فحلَّقت في سمائي الآية ﴿ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: 56].
ولكني أعبُده!
ولكني لا أعبده!
أنا أعبده بالمعنى الظاهريِّ السطحي.
ربما لذلك لا أعبده.
ولا أجدُ في العبادة جوهرَ الحياة التي سُخِّر لها كلُّ ذلك.
هذا لأني أؤدِّيها بحركاتٍ ظاهريَّة وقلبٍ غائب.
كرياضة بدنيَّة، بيد أنها لم تؤثِّر في القلب فلم تُحْيِه، أو تزد عدد النبضات، لم تلملم بقايا الرُّوح من شتات، ولا هي تغني بعد ممات، لم تقم بدورها وتبنِ الذَّات.
ففي الجسد مضغةٌ أنَّي له صلاحه وهي غافلةٌ في سُبات؟
لا توقن أو تؤمن، أو تصدق أو تعتبر لِمَا هو آت.
نُسرف وقتها بغير عِبرة مما فات.
وقفة
لتُحيي الرُّوح قبل أن تُحيا العظام والرُّفَات.
لأنه لا بد أن تكون الدنيا زادًا لمقتات.
يضيء فيها اليقين كلَّ صدر عاتٍ.
دُلَّني يا رب السماوات.
وتكمُن هنا أول البداية.
صِدقٌ في التطهير.
لأنه إذا ما صدق القلب تبعته كلُّ الجوارح بفروض الولاءِ والطاعة.
يليه العزم على الوصول، فلا يبرح حتى البُلوغ.
كل ذاك التسخير لي؛ لأنفرد أنا بمهمة تختلف.
كل المخلوقات تعبد، ولكني أختلف.
أزيد على الإيمان الإبداع.
فرغم اختلاف النشاطات فإن جميعها عبادةٌ، إذا ما كلُّها اشترك لرضا الله سبحانه وتعالى.
ولا يكون ذلك إلا بالنية.
ولما يعظم شأن الله في القلب تتعدد النيات.
لا تستهن بيقين القلب.
فبإيمانه نحيا.
فإذا آمَن أنه يعيش عاش، ولو اجتمعت عليه أسباب الدنيا.
ويثبت ذلك في إحدى الدراسات المبنية على تجارب مادية، عندما قام عالِم بتصفيةِ دماء أحد المحكوم عليهم بالإعدام، وذلك بتوصيل أحد الأنابيب بأوردته؛ ليتقطر دمُه أمام عينيه.
ويا للعجب! بعد فقدان المقدار المحدَّد من الدم مات.
وعجب ذلك؛ لأنه لم يكن الذي يتقطر منه دمُه، بل كان سائلًا آخر يشبه الدم، أمَّا هو، فلم يفقد قطرةً من دمه.
فمات بالوهم.
لأن قلبه لم يؤمن بالحياة.
ليس له ربٌّ هو على كل شيء قدير.
ولأن قلبه مغيَّب عن الإيمان.
كانت الخدعة على عقله الذي صدَّق وتوقَّف حال موته.
فالبصيرة ليست رؤيا العين، بل كامنة حيث اليقين والتعلُّق.
ولما كان الشغل الشاغل هو القلب، كانت علومُه أهمَّ العلوم، وعلم عقيدته بالإسلام من أشرفها.
فإذا هوى اعتقادُ القلب، ضاع كل شيء.
أمَّا الخافق النابض، فيكفيه من الابتلاء شرفًا أن يكون من الله، ومن سعيه عظمةً أنه في سبيل الله إرضاءً له.
فيجد في ﴿ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: 56] ومضة المجرَّة بما تحوي من إعجازٍ وعظمة؛ لتليق العبادة بعظم شأن المعبود.
ويدرك السرَّ الذي إليه يحيا، وبه يحيا، وله يموت، وعليه يموت.
كلما زاد الانتماء للشيء، عظُم في قلبك أمرُه.
وقدر عبادة مَن الأرضُ جميعًا في قبضته

 الإهداءات
الإهداءات







 (إظهار)
الاعضاء الذين قاموا بقراءة الموضوع منذ 10-19-2024, 01:07 PM
(تعيين) (حذف)
(إظهار)
الاعضاء الذين قاموا بقراءة الموضوع منذ 10-19-2024, 01:07 PM
(تعيين) (حذف)
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
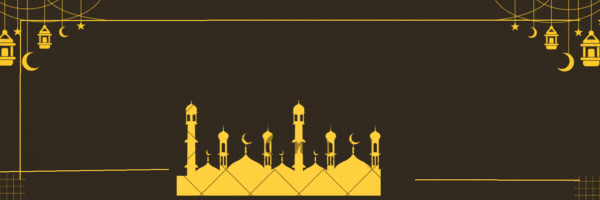


























 العرض العادي
العرض العادي
